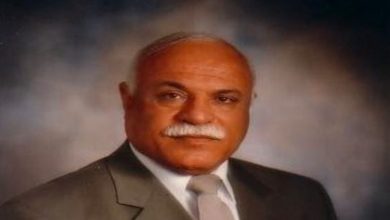قراءة قرآنية فلسفية في العلاقة بين المعرفة، الوعي، والفتنة في واقعنا المعاصر
بقلم: نهاد الزركاني
قبل الدخول في النص، لا بد من توضيح منهجي ضروري:
هذه الكتابة ليست تفسيراً قرآنياً، ولا تدّعي ذلك، فنحن لسنا في مقام التفسير ولا نزاحم أهله، ما نقدّمه هنا ليس إلا قراءة تأملية فلسفية لآية قرآنية، تنطلق من فهم إنساني متواضع، قابل للخطأ والصواب، ومحكوم بسياقنا وقلقنا وأسئلتنا المعاصرة.
كما أن هذه القراءة لا تنطلق من فراغ ذهني، بل من تشخيص واقع يفرض نفسه بإلحاح، واقع تتكدس فيه المعارف، وتضمحل فيه القدرة على الوعي، وتتحول فيه الحقيقة من عبء أخلاقي إلى مادة للاستهلاك الخطابي.
في هذا السياق تأتي الآية: ((فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ))، لا بوصفها موضوعاً للتفسير، بل بوصفها سؤالاً مفتوحاً عن طبيعة الإدراك الإنساني.
الآية تنفي العمى الحسي، وتعيد توجيه الأزمة إلى موضع أعمق: القلب. والقلب هنا (بحسب لغة القرآن لا لغة الشائع) ليس وعاءً للعاطفة، بل مركزاً للوعي والموقف، فالمشكلة ليست في أن الإنسان لا يرى، بل في أنه يرى ثم ينسحب من تبعات ما يرى.
وهنا يبرز الفرق الجوهري بين المعرفة والوعي، فالمعرفة قد تكون مجرد امتلاك معلومات، أو قدرة على التحليل، أو حفظ للنصوص، أما الوعي، فهو الاستعداد لتحمّل نتائج المعرفة، والجرأة على اتخاذ موقف أخلاقي منها، ولهذا يمكن للإنسان أن يعرف كثيراً، ويظل [قرآنياً] أعمى.
لماذا لم يقل النص: ((تعمى العقول))؟
لأن العقل قادر على التكيّف، وعلى إنتاج مبررات ذكية للهرب من الحقيقة، بينما القلب هو موضع الانحياز: إمّا أن يواجه، أو أن يبرّر، أو أن يصمت، العمى، بهذا المعنى، ليس نقصاً معرفياً، بل خياراً وجودياً يتراكم.
ومن هنا يصبح الواقع المعاصر عنصراً ضاغطاً في هذه القراءة، فنحن نعيش زمناً يفيض بالخطاب الديني والثقافي، وبالدعاوى المعرفية، وبالمنابر والمنصات، ومع ذلك تتسع الهوة بين ما يُقال وما يُفعل، وبين ما يُعرف وما يُعاش.
هذا التناقض هو الذي يدفعنا للتركيز على مفهوم الوعي، لا بوصفه ترفاً فكرياً، بل بوصفه حاجة أخلاقية ملحّة، الأخطر من الجهل، في هذا السياق، هو ما يمكن تسميته ((تفاهة المعرفة)) معرفة بلا بوصلة، بلا مسؤولية، بلا همّ جمعي، معرفة تُستخدم لشق الصف، وتفكيك المجتمع، وتبرير الانقسام، وتغذية الصراع، تحت عناوين براقة، أصحاب هذا النمط قد يمتلكون اللغة، والمعلومة، والمنصة، لكنهم يفتقدون الوعي الذي يجعل المعرفة عنصر بناء لا أداة ارتزاق.
في هذا الإطار، لا يمكن فصل تفاهة المعرفة عن صناعة الفتنة، فالتاريخ والواقع معاً يثبتان أن الفتن الكبرى لم تُشعلها الجماهير الجاهلة بقدر ما غذّاها أشباه العارفين أولئك الذين يمتلكون من المعرفة ما يكفي لإقناع الناس، ويفتقدون من الوعي ما يكفي لردع أنفسهم، هؤلاء لا يخطئون لأنهم لا يعلمون، بل لأنهم يعلمون ويختارون توظيف العلم في غير موضعه، فيحوّلونه إلى أداة شقّ لا جسر جمع، وإلى وقود انقسام لا وعي نقدي.
تفاهة المعرفة لا تعني سطحيّتها، بل انفصالها عن المسؤولية، هي معرفة بلا ضمير، وبلا إحساس بعواقب الكلمة، وبلا خوف على المجتمع، ومن هنا تصبح بعض الخطابات (مهما بدت عقلانية أو متماسكة لغوياً) جزءاً من معمل الفتنة، لأنها تُقدَّم بوصفها ((وعياً)) بينما هي في حقيقتها انسحاب أخلاقي مغطّى بلغة فكرية.
الفتنة لا تحتاج دائماً إلى كذب صريح، يكفيها نصف حقيقة، أو قراءة مبتورة، أو معرفة تُنزَع من سياقها، وتُلقى في ساحة مشحونة، وهنا تتجلّى خطورة العمى القلبي الذي تحدّثت عنه الآية: عمى لا يمنع صاحبه من الكلام، بل يمنحه جرأة مضلِّلة، ويجعله واثقاً وهو يقود الآخرين نحو الانقسام.
لا يحاسب القرآن الإنسان على مقدار ما يمتلك من معلومات، بل على موقفه مما أدركه، العمى، في هذا المنظور، ليس قدراً مفروضاً، بل نتيجة تراكم تنازلات داخلية، حتى يغدو الحق ثقيلاً، والباطل مريحاً، والصمت حكمة.
من هنا، لا تكون أزمتنا أزمة تفسير، ولا أزمة نصوص، بل أزمة وعي، أزمة قلوب فقدت شجاعتها في زمن كثرت فيه الأصوات وقلّت المواقف.
وهذا ما يجعل السؤال القرآني حيّاً وملحّاً اليوم:
كيف نعرف كل هذا… ولا نعيه؟