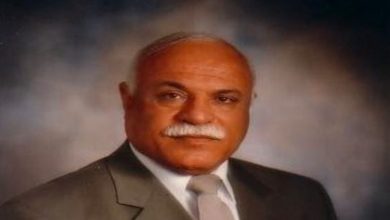كتب د. أسامة أبو شعير: سؤال تجيب عنه مجتمعات تقدمت بالأخلاق قبل التقنية، كيف يمكن لعصر يملك أضخم مخزون معرفي في تاريخ البشرية أن يفقد في الوقت نفسه أبسط مبادئ الأخلاق؟، وكيف وصلنا إلى لحظة أصبح فيها الإنسان أذكى، لكنه ليس بالضرورة خير أو أعدل أو أرحم؟ وهل يمكن حقاً أن تتقدم التقنية بينما يتراجع الضمير؟.
نسأل أنفسنا: متى بدأ هذا الانهيار الأخلاقي؟ هل بدأ يوم تراجع السؤال القديم: “هل هذا حق؟” ليحل محله سؤال آخر أكثر أنانية: “هل هذا يناسبني؟ هل يخدمني؟ هل يعزز صورتي؟”.
وهل يمكن لمن يقيس كل شيء بمقياس المنفعة أن يبقى قادراً على رؤية الحقيقة أو الوقوف عند حدودها؟، وإذا كانت المعرفة اليوم تتضاعف كل دقائق، فلماذا لا تتضاعف معها الحكمة؟ كيف أصبح الإنسان قادراً على غزو الفضاء وفك الشيفرة الوراثية، لكنه غير قادر على تهذيب غضبه وكبح أطماعه واحترام حدود غيره؟ وهل يعقل أن يعرف العالم تركيب الذرة، ولا يعرف طريق العدل؟.
ثم يطلّ علينا سؤال مربك آخر: ما موقع عبودية الله في زمن التقنية والذكاء الاصطناعي؟ أهي تعارض العلم الحديث أم تحميه من الانفلات؟ أهي عبء على العقل أم ميزانه؟ وهل يمكن للعلم أن يكون نعمة إذا خرج من إطار الأخلاق، أو أن تتحول الحرية إلى فوضى إذا غابت عنها المرجعية التي تعيد الإنسان إلى حجمه الحقيقي؟.
إن الذكاء الاصطناعي لا يعرف الحلال والحرام، ولا الخير والشر، ولا معنى العدالة، آلة تتعلم من البيانات وتعمل بالخوارزميات، بلا قلب ولا ضمير، فكيف نأتمن على هذه القوة العمياء إنساناً فقد البوصلة الأخلاقية؟ وكيف نضمن ألا تتحول التقنية إلى أداة للهيمنة أو وسيلة للظلم أو سلاحاً يتجاوز حدود العقل البشري نفسه؟.
وهل تكفي قوانين التنظيم لضبط هذا التقدم الهائل؟ أم أن العالم بحاجة إلى وازع أعمق من تشريعات البشر؟ من الذي يردع الإنسان حين يكون قادراً على الإفلات من العقاب؟ ومن يمنعه من إساءة استخدام القوة إن لم يكن في داخله خوف من الله، وخشية من حساب لا يغفل؟.
وفي خضم هذا كله، يبقى السؤال الأعمق يحوم حولنا: هل يستطيع الإنسان أن يتطور معرفياً من دون أن يتطور أخلاقياً؟ وماذا يعني التطور نفسه إذا كان يبني عالماً أسرع وأقوى، لكنه أكثر جفافاً وقسوة؟ ألسنا بحاجة إلى معنى يسبق التقنية، وإلى ضوء يهدي العلم، وإلى قلب يمشي جنباً إلى جنب مع العقل؟.
وفي النهاية نعود إلى السؤال الذي لا يفقد جدّته: من يعرف الله حقاً؟ هل هو من يحسن الحديث عنه، أم من يحسن الطاعة له؟ وهل المعرفة التي لا تنعكس في السلوك إلا وهمٌ كبير؟ أيمكن لعالم في التكنولوجيا أن يكون جاهلًا بنفسه؟ ولرجل بسيط أن يحمل من نور الأخلاق، ما يعجز عنه مثقف يعيش فوق جبلٍ من المعلومات؟.
إن التقدم العلمي لا يصبح خطراً إلا حين يفقد الإنسان مرجعيته، والذكاء الاصطناعي لا يتحول تهديداً إلا حين يفقد الإنسان خشية ربه، فلا العلم وحده ينقذنا، ولا التقنية وحدها ترشدنا، ولا الذكاء وحده يبني مستقبلاً إنسانياً.
فهل نملك الشجاعة لأن نسأل أخيراً: هل أصبحنا نعرف أكثر ولكن نعيش أقل؟ وهل يمكن أن يعود الإنسان إلى قلبه قبل أن يسحقه عقله؟ وهل نملك أن نعيد الأخلاق إلى مركز المعرفة قبل أن يصبح العلم بلا روح؟.
وهنا يصبح السؤال الضروري بعد كل هذا التأمل: ماذا يعني كل ما سبق للتربية والتعليم اليوم؟ وهل يمكن للمدرسة في هذا العالم المندفع نحو الذكاء الاصطناعي أن تظل مجرد مؤسسة لنقل المعرفة، أم أنها مدعوة لدور أكبر بكثير… دور صناعة الضمير؟.
فالتعليم الذي نحتاجه اليوم ليس تعليماً يضيف إلى عقول الطلاب معلومات جديدة كل يوم، بل تعليماً يضيف شيئاً إلى إنسانيتهم، تعليماً يعيد إليهم القدرة على التمييز، والشجاعة على قول الحق، والقدرة على احترام حدود القوة، واحترام الإنسان مهما اختلف، تعليماً يفهم أن الأخلاق ليست مادة منفصلة، ولا نشاطاً أسبوعياً، بل جوهر العملية كلها، روحها وبدايتها ونهايتها.
وهل هذا حلم مثالي؟ ربما يبدو كذلك، لكنه في الحقيقة صورة واقعية نراها أمامنا في مجتمعات سبقتنا بأخلاقها قبل تقنيتها، مجتمعات مثل اليابان أو دول الشمال الأوروبي، حيث لا تُرفع الشعارات الدينية كثيراً، لكن تُمارَس القيم التي يقوم عليها الدين بأعمق ما يمكن: احترام الوقت، المسؤولية، الانضباط، صدق العمل، الإحساس بالجماعة، والحياء من الخطأ.
تلك المجتمعات لم تعرف الله من طريق الوحي، لكنها اقتربت من كثير من معانيه من خلال منظومة أخلاقية نظيفة، عاقلة، منضبطة، وربما لهذا السبب تحديداً نجحت في بناء إنسان يعرف كيف يستعمل علمه دون أن يتحول إلى خطر على نفسه أو على العالم.
وهنا يصير السؤال أكثر إلحاحاً: لماذا يصعب علينا نحن – الذين نحمل ميراثاً دينياً عظيماً – أن نصنع نظاماً تربوياً يستثمر هذا الميراث ليصنع ضميراً حياً، ووجداناً يقظاً، وإنساناً يعرف حدود قوته؟ ولماذا نكتفي أحياناً بالشعارات والمناهج، ونغفل عن التربية التي تجعل الأخلاق أسلوب حياة، لا مادة تُدرّس في فصل؟.
قد يكون السبب أننا اعتقدنا أن الإيمان يكفي وحده، وأن المعرفة تكفي وحدها، وأن الخطاب الأخلاقي يكفي وحده، بينما الحقيقة أن الإنسان لا يكتمل إلا حين تجتمع المعرفة مع القيمة، والخشية مع العقل، والضمير مع القدرة، وهذا بالضبط ما يجب على المدرسة أن تصنعه اليوم: أن تربّي عقلاً يعرف وقلباً يخشى وضميراً يهدي.
إن التربية التي تصنع الإنسان الأخلاقي ليست طوباوية وليست حلماً بعيداً وليست خيالاً، إنها ضرورة، بل هي الشرط الأخير لنجاة الإنسان في عالم يفوقه ذكاءً وقوة، لكنه لا يفوقه في القدرة على الخير أو الشر، وإن المجتمعات التي سبقتنا لم تفعل ذلك لأنها أكثر علماً، بل لأنها أكثر التزاماً بمنظومة سلوكية يومية تُنتج ضميراً حياً.
لذلك يبقى السؤال المفتوح، وربما الأهم في زمن التكنولوجيا: هل نريد أن نصنع عقولاً فقط أم نريد أن نصنع بشراً؟ وهل سنقبل بتعليم يخرّج أجيالاً تعرف كل شيء عن العالم، لكنها لا تعرف شيئاً عن نفسها؟ أم نملك الشجاعة لنبني تعليماً يعيد الإنسان إلى مركز العملية كلها ويرد للأخلاق مكانها ويستعيد للضمير سلطته؟.
إن كل علم بلا أخلاق قوة ناقصة، وكل تقدم بلا ضمير خطوة نحو الهاوية، وكل تعليم لا يصنع إنساناً، لا يستحق اسمه، وهنا يبدأ التغيير وهنا فقط يمكن للأمم أن تُبنى بحق