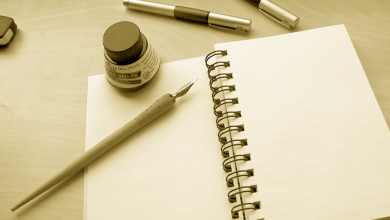كتب سيف الحمداني: في كل دورة انتخابية جديدة، يعود المشهد السياسي العراقي ليطرح نفسه بسلسلة من التساؤلات حول آليات الاختيار، ومعايير الترشيح، وأدوات التأثير على الناخب.
فالأحزاب والكتل السياسية، في سعيها للفوز بأكبر عدد من المقاعد، تلجأ إلى ما يشبه “الخلطة الاجتماعية” التي تجمع بين شخصيات من خلفيات مختلفة: شيخ عشيرة له ثقله الاجتماعي، رجل دين يمتلك حضوره الروحي، أكاديمي أو أستاذ جامعي يملك شهادة عليا، فنان أو إعلامي أو رياضي يحظى بشعبية واسعة.
هذه التوليفة المتنوعة تبدو وكأنها تعكس صورة المجتمع العراقي، لكنها في حقيقة الأمر نتاج معادلات انتخابية تهدف إلى ضمان الأصوات، أكثر مما تهدف إلى تمثيل حقيقي للكفاءة والنزاهة.
غير أن هذه الشخصيات، على اختلاف مواقعها وخبراتها، لا تملك عادة مساحة واسعة للحركة المستقلة، فهي تدخل تحت سقف الكتلة السياسية التي تتبناها، وتلتزم بتوجهاتها وبرامجها، وربما بقراراتها وتحالفاتها المستقبلية.
وهكذا، يتحول المرشح من شخصية يُنتظر منها أن تمثل ناخبيها إلى واجهة سياسية تخضع لإرادة الكتلة، فيفقد الناخب شيئاً من ثقته بأن صوته سيصنع الفارق أو يعبر فعلاً عن إرادته.
في جانب آخر، تعتمد بعض القوائم على التمثيل النسوي باعتباره عنصراً مؤثراً في جذب الناخبين، غير أن هذا التمثيل، في حالات عديدة، يبقى شكلياً أكثر من كونه جوهرياً، إذ تُقدَّم بعض المرشحات كرموز انتخابية أكثر من كونهن مشاريع سياسية متكاملة.
وهنا يُطرح سؤال مهم: هل المطلوب أن يكون حضور المرأة في القوائم عاملاً للتغيير والإصلاح، أم مجرد وسيلة لاستمالة الناخبين؟.
أما الناخب العراقي، فهو يقف وسط معادلة معقدة، حبال متعددة تشده: القرابة، العشيرة، الصداقة، الشهرة، وربما المال السياسي.
وفي خضم هذه المؤثرات، يبتعد أحياناً معيار الكفاءة والنزاهة الذي يفترض أن يكون حجر الأساس في عملية الاختيار، ويجد المواطن نفسه أمام خيارات قد لا تعبّر بالضرورة عن طموحه في التغيير، بقدر ما تعكس ضغوطاً اجتماعية أو مؤثرات ظرفية.
التباين في الوعي والثقافة بين شرائح المجتمع يلعب دوراً إضافياً في صياغة هذا المشهد، فبينما يبحث بعض الناخبين عن برامج إصلاحية واقعية، يكتفي آخرون بالتصويت لمن يعرفونه أو يثقون به اجتماعياً، هذا التفاوت يجعل الأحزاب تلجأ إلى خطابات متعددة، تتنوع بين وعود خدمية، شعارات إصلاحية، أو استمالات عشائرية ودينية، في محاولة لإرضاء أكبر عدد من الناخبين.
ولعل التحدي الأكبر أمام التجربة الديمقراطية في العراق يكمن في هذه النقطة بالذات: أن تتحول الانتخابات من سباق نفوذ وأدوات تأثير إلى منافسة برامج ومشاريع تنموية، فالانتخابات ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لإنتاج نخب سياسية جديدة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي تنتظر البلد.
إن استعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية تتطلب وعياً أكبر من الناخب نفسه، واستعداداً من القوى السياسية لتقديم برامج واضحة وقابلة للتنفيذ، بعيداً عن الشعارات العامة أو الحسابات الضيقة، فالصندوق لا يغير وحده، إنما الذي يغير فعلاً هو الإرادة الحرة التي تضع الورقة فيه، والبرامج الواقعية التي تُبنى على أساسها تلك الورقة.
هكذا يمكن أن تنتقل العملية الانتخابية من كونها “صوتاً ضائعاً” إلى فعل حقيقي يفتح باب الإصلاح ويعزز استقرار الدولة، ويعيد للمواطن ثقته بأن صوته مسموع ومؤثر.